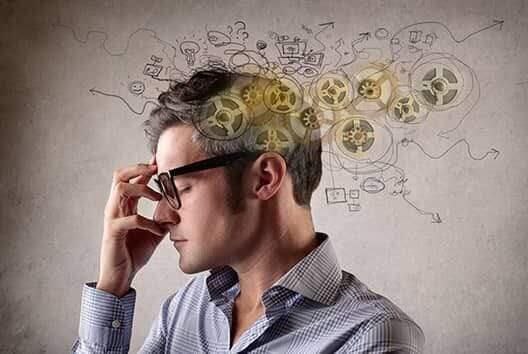رئيس جمعية معدات الأدوية والأجهزة الطبية / ومن خلال خبرته الطويلة في مجال الصحة العامة وتطوير النظام الصحي، مدعومة بأبحاث علمية موثوقة وتجارب ميدانية، يسعى جيذري إلى تسليط الضوء على أبعاد هذا الاضطراب الصامت الذي كثيراً ما يُغفل عنه في الخطاب العام.
يشير مفهوم «الشرود الذهني» (Mind Wandering) إلى حالة من عدم الاستقرار في التركيز الذهني، حينما يعجز الفرد عن توجيه انتباهه إلى اللحظة الراهنة، وتبدأ أفكاره في الانجراف لا إرادياً إلى الماضي أو المستقبل أو إلى مواضيع غير ذات صلة. أما عندما تتحول هذه الحالة إلى نمط دائم تغلب عليه الأفكار السلبية والمتكررة وغير المجدية، فيُطلق عليها علم النفس مصطلح «الاجترار الفكري».
ويؤكد جيذري أنّ هذا النوع من التفكير لا يُعد مجرد تحدٍ فردي، بل يُمثّل تهديداً واسع النطاق على الإنتاجية المجتمعية، وتماسك الأسر، وحتى على اقتصاد الصحة العامة.
فخلافاً للأفكار العابرة أو الخيالات المحايدة، يتمحور الاجترار الفكري حول مشاعر الذنب، وانعدام القيمة، والخوف من المستقبل، واسترجاع الذكريات المؤلمة. وقد أظهرت دراسات علم الأعصاب أنّ الاجترار يُنشّط مناطق معينة من الدماغ مثل القشرة الجبهية الأمامية (Prefrontal Cortex) وشبكة الوضع الافتراضي (Default Mode Network)، مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة النفسية للفرد، ويُفاقم اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب الحاد، القلق العام، اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والوسواس القهري (OCD).
ويُحذر جيذري من أنّ استمرار هذا النمط من التفكير دون تدخل مهني قد يؤدي إلى حلقة مفرغة: فالأفكار المتطفلة تُضعف تركيز الفرد وأدائه، مما يُولّد شعوراً بالفشل، والذي بدوره يُغذي مزيداً من الاجترار. وإذا لم يُكسر هذا النمط، فقد يُفضي إلى العزلة، واضطرابات النوم، وتراجع القدرة على اتخاذ القرار، وفقدان الدافع، وأفكار إيذاء الذات.
وفي تحليل موسع للآثار المجتمعية، يُوضح جيذري أنّ الاجترار الفكري، رغم كونه عملية عقلية داخلية، إلا أن له نتائج ملموسة في الواقع. ففي بيئة العمل، يعاني الموظفون المصابون بالاجترار المزمن من الإرهاق، وكثرة الأخطاء، والغياب الطويل، وانخفاض الرضا الوظيفي. وفي المؤسسات التعليمية، يُواجه الطلاب صعوبة في التعلم الفعّال عندما تُهيمن المخاوف أو الفشل السابق على أفكارهم. ويضيف جيذري أنّ هذا النمط يُضعف إنتاجية القوى العاملة ويزيد من تكاليف العلاج النفسي في النظام الصحي بشكل ملحوظ.
ومن زاوية اجتماعية، يربط جيذري بين تنامي هذه الظاهرة وارتفاع معدلات الطلاق، وانخفاض التسامح الاجتماعي، وخلل في أداء المؤسسات. ويشير إلى أن الاجترار الفكري يُسهم خفيةً في تراجع القدرة العامة على التحمل، ويُفاقم التوترات داخل العائلات والمنظمات. كما يُنبه إلى أن صُنّاع القرار الذين يقعون في أسر التفكير السلبي المغلق قد يعجزون عن تبني رؤى استراتيجية تُراعي المصلحة الوطنية. لذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يُعد ضرورة لا على مستوى الفرد فقط، بل ضمن إطار تحسين جودة الحوكمة.
ويرى جيذري أن إدارة الاجترار الفكري تتطلب العمل على ثلاثة مستويات: الوقاية، التدخل العلاجي، والتأهيل الاجتماعي. فعلى صعيد الوقاية، يبرز دور تعليم مهارات مثل الوعي الذهني، والمرونة النفسية، وإدارة التوتر، وتنظيم الانفعالات، وذلك عبر المدارس، ووسائل الإعلام، وبيئات العمل. كما يدعو إلى دمج الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية، ويحث النقابات والإعلام على إطلاق حملات توعوية، مُشيراً إلى نماذج ناجحة في الدول الإسكندنافية، حيث أدّت هذه المبادرات إلى تقليص معدلات الاضطرابات النفسية بشكل ملموس بين المراهقين.
أما على مستوى التدخل، فيُشيد بالعلاج المعرفي السلوكي (CBT) كمنهج فعّال لتعديل الأنماط الذهنية السلبية، بالإضافة إلى العلاج القائم على القبول والالتزام (ACT) والعلاج السلوكي الجدلي (DBT) في الحالات المعقدة. ويُشير إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب أو القلق تُستخدم في الحالات الشديدة فقط وبإشراف طبيب نفسي مختص، مؤكداً أنّ العلاج لا يقتصر على الدواء، بل يتطلب مشاركة نشطة من المريض، وتغيير نمط الحياة، وتعزيز العلاقة مع المعالج، والاندماج التدريجي في الأنشطة اليومية.
كما يولي أهمية بالغة لدور العائلة والأصدقاء والمرافقين في رحلة العلاج. إذ يرى أن من يُعاني من الاجترار الفكري يحتاج قبل كل شيء إلى الإصغاء، والتعاطف، والشعور بالأمان النفسي. ويوصي المحيطين به بالابتعاد عن النصائح الجاهزة والأحكام، والتركيز على الإنصات الفعّال، وتقديم الدعم في المواعيد العلاجية، وتشجيع العادات الصحية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وفي ختام المقال، يُوجه جيذري نقداً إلى ضعف الاهتمام المؤسسي بالصحة النفسية، مُشيراً إلى أنّ المجتمع يحتاج إلى “معدات ذهنية” بقدر حاجته إلى المعدات الطبية الملموسة. ويُطالب بتخصيص ميزانيات واضحة للعلاج النفسي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي للاستشارات النفسية، وتدريب كوادر متخصصة في مراكز محلية، وتوفير الدعم الإعلامي للنقاش العام حول قضايا الصحة العقلية.
ويحذر من أن تجاهل هذه المسألة في عالمٍ يزداد فيه الشعور بالوحدة الرقمية، وانعدام الأمان الاقتصادي، والتآكل النفسي، قد يؤدي إلى نشوء جيل يبدو سليماً في مظهره، لكنه منهك من الداخل، وعديم الحافز.
ويختتم الدكتور عليرضا جيذري مقاله بالتأكيد على الدور المحوري للنقابات الصحية في تعزيز الصحة النفسية. ويُوصي جمعية معدات الأدوية والأجهزة الطبية في طهران بتدشين حملات توعوية، وإعداد كتيّبات إرشادية للمرضى وذويهم، وإنشاء عيادات استشارية في المناطق المهمّشة، كخطوة نحو نموذج تكاملي يجمع بين الصحة الجسدية والنفسية. وهو يرى أن هذه المبادرة ليست مجرد خيار، بل واجب أخلاقي على كل جهة تنتمي إلى منظومة الرعاية الصحية.
لقد تحدث جيذري في هذا المقال، لا بصفته ممثلاً لنقابة مهنية فقط، بل كصوت للضمير المجتمعي، ساعياً إلى جذب الانتباه نحو خطر صامت، لكنه عميق الأثر. فالعقل المنهك يلد جسداً مريضاً، ومجتمع تستهلكه الأفكار المُجترّة لا يمكنه أن يشق طريقه بثبات نحو التنمية والعدالة والرفاه.